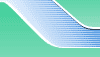(الصفحة61)
التحدّي
بالاخبار عن الغيب
قد وقع في الكتاب التحدّي بالاخبار عن الغيب في آيات متعدّدة ، ونفس الاخبار بالغيب في آيات كثيرة ، ففي الحقيقة الآيات الواردة في هذا المجال على قسمين: قسم وقع فيها التحدّي بنفس هذا العنوان ، وهو الاخبار والانباء بالغيب ، وقسم وقع فيها مصاديق هذا بعنوان من دون الاقتران بالتحدّي ، وقبل الورود في ذكر القسمين والتعرّض لمدلول النوعين لابدّ من التنبيه على أمرين:
الأمر الأوّل: انّ المراد بالغيب في هذا المقام هو ما يدركه الإنسان ولا ينال إليه من دون الاستعانة من الخارج ، ولو أعمل في طريق الوصول إليه جميع ما أعطاه الله من القوى الظاهرة والباطنة ، فهو شيء بينه وبين الإنسان بنفسه حجاب ، ولابدّ من الاستمداد من الغير في رفع ذلك الحجاب ، وكشف ذلك الستار ، وعليه فالحادثة الواقعة الماضية ، والقضية الثابتة المتصرّمة تعدّ غيباً بالإضافة إلى الإنسان ، لأنّه لا يمكن له أن يطّلع عليها ، ويصل إليها من طريق شيء من الحواس والقوى ، حتّى القوّة العاقلة المدركة ، فإنّ وجود تلك الحادثة وعدمها بنظر العقل سواء; لعدم كون حدوثها موجباً لانخرام شيء من القواعد العقلية ، كما هو المفروض ، ولا كون عدمها مستلزماً لذلك كذلك ، وإلاّ لا يكاد يمكن أن تتحقّق
(الصفحة62)
على الأوّل ، أو لا تتحقّق على الثاني ، كما أنّه بناءً على ما ذكر في معنى الغيب في المقام لا يكون ما يدركه العقل السليم ، والفطرة الصحيحة من الحقائق من الغيب بهذا المعنى الذي هو المقصود في المقام ، فوجود الصانع ـ جلّ وعلا ـ لا يعدّ من المغيبات هنا ، لأنّ للعقل إليه طريقاً بل طرقاً كثيرة ولا حاجة له في الوصول إليه تعالى والاعتقاد بوجوده إلى الاستمداد من الغير ، والاستعانة من الخارج.
وبالجملة: فالغيب في المقام ليس المراد به هو الغيب في مثل قوله تعالى في سورة البقرة 3: {الذين يؤمنون بالغيب} بل المراد به هو الغيب في مثل قوله تعالى في سورة الأنعام 59: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو} الآية.
لا أقول: إنّ للغيب معان مختلفة ، فإنّه من الواضح الذي لا يرتاب فيه عدم كون لفظ الغيب مشتركاً بين معان متعدّدة ، فإنّه في مقابل الشهود الذي لا يكون له معنى واحد ، غاية الأمر اختلاف موارد الاستعمال باختلاف الأغراض والمقاصد بحسب المصاديق والافراد ، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: أنّ دلالة الاخبار بالغيب على الإعجاز تظهر ممّا ذكرناه في معنى الغيب ، فإنّه بعدما لم يكن للإنسان سبيل إلى الاطّلاع على المغيبات من قبل نفسه; لعدم الملائمة بينه بقواه الظاهرة والباطنة وبين الاطّلاع عليها بدون الاستعانة والاستمداد ، فإذا فرضنا إنساناً أتى بكتاب مشتمل على الاخبار بالغيب ، وعلمنا عدم اطّلاعه عليها من قبل نفسه ، والجماعة التي هو فيهم ومعهم; نعلم جزماً بانحصار طريق الوصول إليه في مبدأ الوحي ، ومخزن الغيب ، ومن عنده مفاتيحه ولا يعلمها إلاّ هو ، وبه يتحقّق التحدّي الموجب للإعجاز. إذا عرفت ما ذكرنا من الأمرين ، فنقول:
(الصفحة63)
من القسم الأوّل: من الآيات ، قوله تعالى في سورة آل عمران في قصّة مريم 44: {ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون} وقوله تعالى في سورة هود 49: {تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا} وقوله تعالى في سورة يوسف بعد ذكر قصّته 102: {ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون}.
ومن القسم الثاني: آيات كثيرة متعدّدة واقعة في موارد مختلفة:
منها: قوله تعالى في سورة الحجر 94 ـ 96: {فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انّا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون}.
فإنّ هذه الآيات نزلت بمكّة في ابتداء ظهور الإسلام ، وبدء دعوة النبيّ ، والسبب في نزولها ـ على ما حكي ـ أنّه مرّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على اُناس بمكّة فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون هذا الذي يزعم أنّه نبيّ ، ومعه جبرئيل ، فأخبرت الآية عن نصرة النبي في دعوته ، وكفاية الله المستهزئين والمشركين في زمان كان من الممتنع بحسب العادة انحطاط شوكة قريش ، وانكسار سلطانهم ، وغلبة النبي والمسلمين وعلوّهم ، وقد كفاه الله أشرف كفاية ، وبان للمستهزئين ، وعلموا ما في قوله تعالى في آخر الآية: «فسوف يعلمون» ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة الصفّ المكّية الواردة في مثل الحال المذكور ، والشأن الذي وصفناه من طغيان الشرك ، وسلطان المشركين في بدء الدعوة الإسلامية 9: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون}.
ومنها: قوله تعالى في سورة القمر 44 ـ 45:
(الصفحة64)
{أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولّون الدبر}.
وقد نزل في يوم بدر حين ضرب أبو جهل فرسه وتقدّم نحو الصفّ الأوّل قائلاً: «نحن ننتصر اليوم من محمّد وأصحابه» فأخبر الله بانهزام جمع الكفّار وتفرّقهم ، مع أنّه لم يكن يتوهّم أحد نصرة المسلمين وانهزام الكافرين مع قلّة عدد الأوّلين ، بحيث لم يتجاوز عن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، وضعف عدّتهم ، لأنّ الفارس فيهم كان واحداً أو اثنين ، وكثرة عدد الآخرين ، وشدّة قوّتهم بحيث وصفهم الله تعالى بأنّهم ذوو شوكة ، وكيف يحتمل انهزامهم ، وقمع شوكتهم وانكسار سلطانهم؟ وقد أخبر الله تعالى بذلك ، ولم يمض إلاّ زمان قليل بأن صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)فيما حكاه وأخبره.
ومنها: ما ورد في رجوع النبيّ ، ودخول المسلمين إلى معاده ، والمسجد الحرام من قوله تعالى في سورة القصص 85: {انّ الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد} وقوله تعالى في سورة الفتح 27: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم لا تخافون}.
ومنها: قوله تعالى في سورة الروم 2 ـ 5: {ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله} فإنّ فيه خبرين عن الغيب ظهر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الآية ، فغلبت الروم فارس ، ودخلت مملكتها قبل مضيّ عشر سنين ، وفرح المؤمنون بنصر الله.
وقوله تعالى في سورة المائدة 70: {والله يعصمك من الناس}.
ومنها: قوله تعالى في شأن القرآن في سورة الحجر 9: {انّا نحن نزّلنا الذكر وانّا
(الصفحة65)
له لحافظون} فإنّ القدر المتيقّن من مدلوله هو حفظ القرآن وبقائه ، وعدم عروض الزوال والنسيان له ، وإن كان مفاد الآية أوسع من ذلك ، وسيأتي في بحث عدم تحريف الكتاب الاستدلال بهذه الآية عليه بنحو لا يرد عليه إشكال ، فانتظر.
ومنها: قوله تعالى في سورة تبّت.
في شأن أبي لهب وامرأته: {سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب في جيدها حبلٌ من مسد} وهو إخبار بأنّهما يموتان على الكفر ، ويدخلان النار ، ولا نصيب لهما من سعادة الإسلام الذي يكفِّر آثام الشرك ، ويوجب حطّ آثاره ، ويجبُّ ما قبله ، وقد وقع ذلك في الخارج ، حيث بقيا على الكفر إلى أن عرض لهما الموت.
ومنها: قوله تعالى في سورة النور 55: {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً}.
وقد تنجز بعض هذا الوعد ، ولابدّ من إتمامه بسيادة الإسلام في العالم كلّه ، وذلك عند ظهور المهدي وقيام القائم ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ، وبه تتحقّق الخلافة الإلهية العالميّة ، والسلطنة الحقّة العامّة في جميع أصقاع الأرض ، ونواحي العالم.
ومنها: غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن ، الدالّة على نبأ غيبي كقوله تعالى في سورة الأنعام 65: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض} فإنّ المروي عن عبدالله بن مسعود قال: «إنّ الآية نبأ غيبي عمّن يأتي بعد» وغير ذلك كالآيات
(الصفحة66)
الدالّة على أسرار الخليقة ، ممّا لا يكاد يمكن الاطّلاع عليها في ذلك الزمان ، وسيأتي التعرّض لشطر منها إن شاء الله تعالى.
نعم يبقى في المقام إشكال ، وهو أنّ الاخبار بالغيب كثيراً ما يقع من الكهّان والعرّافين والمنجِّمين ، وكذب هؤلاء ، وإن كان أكثر من صدقهم ، إلاّ أنّه يكفي في مقام المعارضة ، وتحقّق الإشكال ثبوت الصدق ولو في مورد واحد ، فضلاً عمّا إذا كانت الموارد متعدّدة ، فإنّه ـ حينئذ ـ ينسدّ باب المصادفة أيضاً ، لأنّه مع وحدة المورد ، أو قلّة الموارد باب احتمال المصادفة مفتوح بكلا مصراعيه ، وامّا مع التعدّد والكثرة لا يبقى مجال لجريان هذا الاحتمال ، وعليه فكيف يصير الاخبار بالغيب من دلائل الإعجاز ومسوّغاً للتحدّي.
والجواب عن هذا الإشكال يظهر ممّا ذكرناه في تعريف الغيب المقصود بالبحث هنا ، فإنّه ـ كما عرفت ـ عبارة عمّا لا يكاد يدركه الإنسان بسبب قواه الظاهرة والباطنة مع عدم الاستمداد من الغير والخارج ، وعليه فما له سبيل إليه ، وطريق إلى وصوله بسبب القواعد التي بأيديهم التي تلقّوها ممّن علّمهم ، لا يعدّ من الغيب هنا ، فإنّ الاخبار بالغيب الذي يكون من دلائل الإعجاز ، وموجباً لتسويغ التحدّي هو الذي لم يكن لمخبره واسطة إلى استكشافه ، وطريق إلى الوصول إليه ، غير طريق الوحي والاتّصال بمركز الغيب.
وأمّا أخبار هؤلاء فمستندة إلى القواعد التي بأيديهم ، والأوضاع والخصوصيات التي يتخيّلون كونها علائم وإفادات للحوادث الآتية ، مع أنّ التخلّف كثير ، وادّعاء العلم منهم قليل.
(الصفحة67)
التحدّي بالبلاغة
من جملة ما وقع به التحدّي في الكتاب العزيز: البلاغة ، وهي وإن لم يصرّح بها فيه ، إلاّ أنّه يمكن استفادة التحدّي بها من بعض الآيات ، مثل قوله تعالى في سورة يونس 38: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين} وقوله في سورة هود 13 ـ 114: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا فاعلموا إنّما اُنزل بعلم الله} ودلالتهما على التحدّي بالبلاغة إنّما تظهر بعد ملاحظة أمرين:
الأوّل: أنّ العرب في ذلك العصر ـ أي عصر طلوع القرآن ـ وبدء الدعوة الإسلامية ـ قد كانت بعيدة عن الفضائل العلميّة بمراحل ، وعن الكمالات العلمية الإنسانيّة بفراسخ ، بل ـ كما يشهد به التاريخ ـ كانت لهم أعمال وأفعال لا يكاد يصدر من الحيوانات ، فضلاً عن المرتبة الدنيا في نوع الإنسان ، والطبقة البعيدة عن التمدّن من هذا النوع ، نعم قد انحصرت فضيلتهم في البلاغة ، وامتازوا بالفصاحة ، بحيث لم يروا لغيرها قدراً ولا رتّبوا عليه أجراً ، وبلغ تقديرهم للشعر إلى أن عمدوا السبع قصائد من خيرة الشعر القديم ، وكتبوها بماء الذهب ، وعلّقوها على الكعبة ، واشتهرت بالمعلّقات السبعة ، وكان هذا الأمر رائجاً بينهم ، مورداً لاهتمام رجالهم
(الصفحة68)
ونسائهم ، وكان النابغة الذبياني هو الحكم في الشعر ، يأتي سوق عكاظ في الموسم فتضرب له قبّة ، فتأتيه الشعراء من كلّ ناحية ، وتعرض عليه الأشعار ليحكم فيها ، ويرجّح بعضها على بعض.
الثاني: انّ مثل هذا التعبير ، وهو الإتيان بالمثل في مقام المعارضة ، والاحتجاج إنّما يحسن توجيهه إلى المخاطب ، الذي كان له نصيب وافر من سنخ مورد الدعوى وخلاق كامل مناسب لما وقع فيه النزاع ، فلا يقال ـ مثلاً ـ لمن يعترض على كتاب فقهي ـ ككتاب التذكرة للعلاّمة الحلّي ـ ائت بمثله إلاّ إذا كان له حظّ وافر من الفقه ، وسهم كامل من ذلك العلم ، فتوجيه هذا النحو من الخطاب إنّما ينحصر حسنه في مورد خاصّ ، وعليه فدعوة الناس إلى الإتيان بسورة مثل القرآن ، أو بعشر سور مثله ، مع انحصار فضيلتهم في البلاغة إنّما يكون الغرض منها الدعوة إلى الإتيان بمثله في البلاغة ، التي كانت العرب تمتاز بها ، فوجه الشبه في الآيتين وإن لم يصرّح به فيهما ، ولم يقع التعرّض له إلاّ انّه بملاحظة ما ذكرنا ينحصر بالبلاغة ليحسن توجيه مثل هذا الخطاب كما عرفت.
بل قد مرّ سابقاً انّه يمكن أن يقال: إنّ توصيف العشر سور بوصف كونها مفتريات لا يكاد ينطبق ظاهراً إلاّ على المزايا الراجعة إلى الألفاظ ، من دون ملاحظة المعاني وعلوّها ، وعلى الخصوصيات التي تشتمل عليها العبارات ، من دون النظر إلى المطالب وسموّها ، وبهذا الوجه قد تفصّينا عن اشكال مخالفة الترتيب الطبيعي الواقعة في آيات التحدّي بمقتضى النظر البدوي ، كما عرفته مفصّلاً.
وبالجملة: لا ينبغي الارتياب في أنّ العناية في الآيتين إنّما هي بموضوع البلاغة فقط ، مع أنّ كون البلاغة من أعظم وجوه الإعجاز لا يحتاج إلى التصريح به في
(الصفحة69)
الكتاب ، بل يحصل العلم به بالتدبّر في كون الكتاب معجزة عظيمة للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وانّه لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء ، وعيسى بن مريم بآلة الطبّ ، ومحمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكلام والخطب ، مع أنّ المعتبر في حقيقة الإعجاز هو كون المعجز أمراً خارقاً للعادة البشرية ، والنواميس الطبيعيّة ـ كما عرفت تفصيل الكلام فيه ـ وعليه فتخصيص كلّ واحد منهم بقسم خاصّ ونوع مخصوص إنّما هو لأجل نكتة ، وهي رعاية الإعجاز الكامل ، والمعجزة الفاضلة ذات المزيّة الزائدة على ما يكون معتبراً في الحقيقة والماهية ، فإنّ المعجزة إذا كانت مشابهة للكمال الرائج في عصرها ، ومسانخة للفضيلة الراقية في زمانها ، تصير بذلك خير المعجزات ، وتتلبّس لأجله بلباس الكمال والفضيلة الزائدة على ما يعتبر في الحقيقة.
والسرّ في ذلك: انّ المعجزة المشابهة توجب سرعة تسليم المعارضين العالمين بالصنعة ، التي تشابه ذلك المعجز لأنّ العالم بكلّ صنعة أعرف بخصوصياتها ، واعلم بمزاياها وشؤونها ، فإنّه هو الذي يعرف انّ الوصول إلى المرتبة الدانية منها لا يكاد يتحقّق إلاّ بتهيئة مقدّمات كثيرة ، وصرف زمان طويل ، فضلاً عن المراتب المتوسّطة والعالية ، وهو الذي يعرف الحدّ الذي لا يكاد يمكن أن يتعدّى عنه بحسب نواميس الطبيعة ، والقواعد الجارية.
وامّا الجاهل فلأجل جهله بمراتب تلك الصنعة ، وبالحدّ الذي يمتنع التجاوز عنه لا يكاد يخضع في قبال المعجز إلاّ بعد خضوع العالم بتلك الصنعة المشابهة ، وبدونه يحتمل انّ المدّعي قد أتى بما هو مقدور للعالم ، ويتخيّل انّه اعتمد على مبادئ معلومة عند أهلها ، وعليه فإذا كانت المعجزة مشابهة للصنعة الرائجة ، والفضيلة
(الصفحة70)
الشائعة يوجب ذلك أي التشابه والمسانخة سرعة تسليم العالمين بتلك الصنعة ، وبتبعهم الجاهلين ، فيتحقّق الغرض من الإعجاز بوجه أكمل ، وتحصل النتيجة المطلوبة بطريق أحسن.
إذا ظهر لك ذلك يظهر الوجه في اختصاص كلّ نبيّ بمعجزة خاصّة ، وقسم مخصوص ، وانّه حيث كان الشائع في زمان موسى ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ السحر ، وكان القدر والفضيلة إنّما هو للعالم العارف بذلك العلم ، وبلغ ارتقاؤهم في هذا العلم إلى مرتبة وصف الله تعالى سحرهم بالعظمة ، لأنّه كاشف عن بلوغهم إلى المراتب العالية ، والدرجات الكاملة ، بعث الله تبارك وتعالى رسوله بمعجزة مسانخة للعلم الشائع الرائج وعبّر الكتاب العزيز عن تأثير تلك المعجزة بمجرّد الرؤية والمشاهدة ، بأنّه ألقى السحرة ساجدين ، فخضعوا قبالها لمّا رأوها ورأوا أنّ ذلك فائق على القدرة البشرية ، وخارق للقواعد والنواميس الجارية.
وحيث كان الشائع في زمان عيسى ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ ومحلّ دعوته الطبّ ، ومعالجة المرضى ، وتوجّه الناس إلى هذا العلم توجّهاً كاملاً وصار هذا ملاكاً للقدر والفضيلة ، ومناطاً للكمال والمزيّة بعث الله نبيّه بمعجزة مشابهة فائقة ، وهو ابراء الاكمه والأبرص ، وإحياء الموتى.
وحيث كان الرائج في محيط الدعوة الإسلامية علم البلاغة ـ على ما عرفت ـ في الأمر الأوّل ، بعث الله نبيّه الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) بكتاب جامع كامل ، مسانخ للعلم الرائج ، فائق على جميع المراتب التي في إمكانهم ، وتمام المدارج المقدورة لهم ، ليخضعوا دونه بعد ملاحظة تفوّقه عن المستوى المقدور ، وخروجه عن دائرة الإحاطة البشريّة والعلم الإنساني.
(الصفحة71)
فانقدح من جميع ذلك: أنّ العناية بخصوص البلاغة لا تحتاج في الاستدلال عليها إلى وقوع التحدّي بها في نفس الكتاب العزيز ، كسائر المزايا التي وقع التحدّي بها فيه ، بل تظهر بالتأمّل في تخصيص النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذه المعجزة ، مع ملاحظة معجزات سائر الأنبياء المتقدّمين.
نعم ، لا ينحصر وجه التخصيص فيما ذكر ، لأنّ له وجهاً آخر يعرف ممّا تقدّم ، وهو أنّ معجزة الخاتم لابدّ وأن تكون باقية إلى يوم القيامة ، لأنّه كما أنّ الحدوث يحتاج إلى الإثبات من طريق الإعجاز كذلك البقاء يفتقر إليه أيضاً ، لا بمعنى أنّ الحدوث والبقاء أمران يحتاجان إلى المعجزة ، ولابدّ من الإتيان بها لكلّ منهما ، بل بمعنى أنّ النبوّة الباقية لابدّ وأن يكون في بقائها ، غير خال عن الإعجاز ليصدقها من لم يدرك النبيّ ، ولم يشاهده.
ومن الواضح: أنّ ما يمكن أن يكون باقياً إنّما هو من سنخ الكتاب ، ضرورة انّ مثل انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وما يشابههما من المعجزات ـ ممّا لا يتّصف بالبقاء بل يوجد وينعدم ـ لا يمكن أن يكون معجزة بالإضافة إلى البقاء ، إلاّ إذا بلغ إلى حدّ التواتر القطعي بالنسبة إلى كلّ طبقة ، وكلّ فرد ، ومع ذلك لا يكاد يترتّب عليه الغرض المهمّ ، فالكتاب المستظهر بقوله تعالى في سورة الحجر 9: {انّا نحن نزّلنا الذكر وانّا له لحافظون} معجزة وحيدة بالإضافة إلى البقاء والخلود ، كما مرّ البحث في ذلك في توصيف القرآن بخلود الاعجاز.
ثمّ انّ ها هنا إشكالاً ، وهو أنّ البلاغة لا يمكن أن تكون من وجوه الإعجاز ، ولا ينطبق عليها المعجز ـ بما اعتبر في معناه الاصطلاحي المتقدّم في أوائل البحث ـ لأنّه كما عرفت يتقوّم بكونه خارقاً للعادة ، فائقاً على ناموس الطبيعة ، والبلاغة
(الصفحة72)
ليس فيها هذه الخصوصية التي بها قوام الإعجاز. وتوضيح ذلك يتوقّف على أمرين:
أحدهما: انّ دلالة الألفاظ على المعاني وأماريتها لها ، وكشفها عنها ليس لأمر يرجع إلى الذات ، بحيث يكون الاختصاص والدلالة ناشئاً عن ذات الألفاظ بلا مدخلية جاعل وواضع ، بل هذه الخاصّة اعتبارية جعليّة ، منشأها جعل الواضع واعتبار المعتبر ، والغرض منه سهولة تفهيم الإنسان ما في ضميره ، والاستفادة منه في مقام الإفادة ، فالاختصاص إنّما ينشأ من قبل وضع الواضع ، وبدونه لا مسانخة بين الألفاظ والمعاني ولا دلالة لها عليها ، وتحقيق هذا الأمر في محلّه.
ثانيهما: انّ الواضع ـ على ما هو التحقيق ـ هو الإنسان لا خالقه وبارئه ، فإنّه هو الذي جعل اللفظ علامة دالّة على المعنى ، لضرورة الحاجة الاجتماعية ، وسهولة الإفادة والاستفادة ، والتفهيم والتفهمّ.
إذا ظهر لك هذان الأمران: يندقح الإشكال في كون البلاغة من وجوه الإعجاز ، فإنّه إذا كان الوضع راجعاً إلى الإنسان ، مجعولاً له ، مترشّحاً من قريحته ، فكيف يمكن أن يكون التأليف الكلامي بالغاً إلى مرتبة معجزة للإنسان ، مع أنّ الدلالة وضعية اعتبارية جعليّة ولا يمكن أن يتحقّق في اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به القريحة!.
مضافاً إلى أنّه على تقدير ثبوته وتحقّقه ، كيف يمكن تعقّل التعدّد والتنوّع للنوع البالغ مرتبة الإعجاز. والرتبة الفائقة على قدرة البشر؟ مع أنّ القرآن كثيراً ما يورد في المعنى الواحد ، والمقصود الفارد عبارات مختلفة ، وبيانات متعدّدة ، وتراكيب متفرّقة ، سيّما في باب القصص والحكايات الماضية.
(الصفحة73)
والجواب:
عن هذا الإشكال: انّ حديث الوضع ، ودلالة الألفاظ على معانيها ـ وإن كان كما ذكر ـ إلاّ أنّ استلزام ذلك لعدم كون البلاغة من وجوه الإعجاز ممنوع ، فإنّ الموضوع في باب الألفاظ ووضعها للمعاني إنّما هو المفردات ، وامّا البلاغة فهي لا تتحقّق بمجرّد ذلك ، فإنّه من أوصاف الجملة والكلام ، والاتّصاف بها إنّما هو فيما إذا كانت الجملة التي يركبها المتكلّم ، والكلمات التي يوردها ، حاكية عن الصورة الذهنية المتشكِّلة في الذهن ، المطابقة للواقع ، ومن الواضح أنّ تنظيم تلك الصورة ، وإيراد الألفاظ الحاكية لها من الاُمور التي لا ترجع إلى باب الوضع ، ودلالة مفردات الجمل وألفاظ الكلمات ، بل يحتاج إلى مهارة في صناعة البيان ، وفنّ البلاغة ، ونوع لطف في الذهن يقتدر به على تصوير الواقع ، وخصوصيّاته ، وإيجاد الصورة المطابقة له في الذهن.
فانقدح انّ اتّصاف الكلام بالبلاغة يتوقّف على جهات ثلاث ، يمكن الانفكاك بينها ، ومسألة الوضع والدلالة إحدى تلك الجهات ، ولا ملازمة بينها وبين الجهتين الاُخريين.
نعم ، لو قلنا بثبوت وضع للمركّبات ، زائداً على وضع المفردات التي منها الهيئة التركيبية ، بأن كان في مثل: «زيد قائم» وضع آخر زائداً على وضع «زيد» ووضع «قائم» بمادّته وهيئته ، ووضع هيئة الجملة الاسميّة ، وكان الموضوع في الوضع الزائد مجموع هذه الجملة بما هو مجموعها ، ولا محالة يصير الوضع ـ حينئذ ـ شخصيّاً لا نوعيّاً ، كما هو ظاهر ، لكان لهذا الإشكال مجال ، إذ كلّ جملة مؤلّفة لابدّ وأن تنتهي إلى وضع الواضع.
(الصفحة74)
إلاّ أن يقال بثبوت الإعجاز على هذا القول أيضاً ، امّا بالإضافة إلى تركيب الجملات وتأليفها ، لأنّ انتهاء كلّ جملة إلى وضع الواضع لا يستلزم الاستناد إلى الوضع في مجمع الجملات المؤلّفة ، خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا سابقاً من عدم كون الإعجاز وصفاً لكلّ آية من الآيات ، بل غاية ما تحدّى به في الكتاب هو السورة المؤلَّفة من الجملات المتعدّدة ، فالالتزام بالوضع في كلّ جملة لا ينافي الاتّصاف بالإعجاز في المجموع المركّب من الجملات ، كما هو ظاهر ، وامّا بالإضافة إلى الاستعمالات المجازية التي لا يلزم الانتهاء فيها إلى الوضع ـ بشخصها ـ كما لا يخفى.
لكن الذي يسهّل الخطب: انّه لا مجال لأصل هذا القول ، لعدم كون المركّب أمراً زائداً على مفرداتها ، التي منها الهيئة التركيبية ، حتّى يتعقّل فيه الوضع ، وليس هنا من سنخ المعاني معنى أيضاً ، حتّى يفتقر إلى وضع لفظ بإزائه ، وإن نسب هذا القول ابن مالك في بعض كتبه إلى بعض ، ولكنّه أجاب عنه بنفسه وأجاد في مقام الجواب والتحقيق الزائد في محلّه.
ثمّ إنّه قد ظهر من جميع ما ذكرنا: انّه قد وقع التحدّي في الكتاب العزيز ببعض وجوه الإعجاز ، وقد مرّ تفصيله ، وهاهنا وجوه اُخر كثيرة صالحة لأن تكون من وجوه الإعجاز ، وإن لم يقع التحدّي بها فيه ، ولكنّه لا مجال للنقاش في اتّصافها بذلك ، ولا بأس بالتعرّض لبعضها:
(الصفحة75)
القرآن ومعارفه الاعتقادية
من جملة وجوه الإعجاز: اشتمال القرآن على الاُصول الاعتقادية ، والمعارف القلبيّة الراجعة إلى وجود الباري وصفاته الجماليّة والجلاليّة ، وإلى ما يرجع إلى الأنبياء وأوصافهم الكماليّة ، وفضائلهم الاختصاصيّة ، بنحو ينطبق على ما هو مقتضى حكم العقل السليم ، والذوق المستقيم ، مع أنّ المحيط الذي نزل فيه الكتاب لم يكن له سنخيّة مع هذه المعارف والاُصول ، ووجه شباهة مع هذه الحقائق والمطالب فإنّ هؤلاء الذين نشأ النبيّ بينهم ، وفيهم على طائفتين: طائفة كثيرة كانت وثنيّة معتقدة بالخرافات والأوهام ، وطائفة من أهل الكتاب كانت معتقدة بما في كتب العهدين المحرّفة المنسوبة إلى الوحي ، ولو فرضنا انّ النبيّ لم يكن اُمّياً ـ مع أنّه من الوضوح بمكان وقد ادّعاه لنفسه مكرّراً ولم يقع في قباله إنكار وإلاّ لنقل كما هو ظاهر ـ وقد أخذ تعاليمه ومعارفه من تلك الكتب ، وكانت هي المصدر لكتابه ، والمأخذ لقرآنه ، لكان اللاّزم أن ينعكس على تقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد الموجودة في المصادر المذكورة ، مع انّا نرى مخالفه القرآن لتلك الكتب في جميع النواحي ، واشتماله على المعارف والاُصول الحقيقيّة المغايرة لما في تلك الكتب ، من الخرافات التي لا ينبغي أن يشتمل عليها كتاب البشر ، فضلاً عن الكتاب المنسوب إلى الوحي والنبيّ ، وهذا الذي ذكرناه له مجال واسع ، وعليه شواهد كثيرة ،
(الصفحة76)
وأمارات متعدّدة ، ولكنّا نقتصر على البعض خوفاً من التطويل فنقول:
غير خفيّ على من لاحظ القرآن ، انّه وصف الله تبارك وتعالى بما ينطبق على العقل السليم ويتمشّى مع البرهان الصريح ، فأثبت له تعالى ما يليق بشأنه من الصفات الجماليّة ، ونزّهه عمّا لا يليق به من لوازم النقص والحدوث ، فوصفه بأنّه تعالى خالق كلّ شيء ، وانّه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وانّه الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء ، وانّه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وانّه الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ، وانّه سخّر الشمس والقمر وانّه عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم ، وانّه هو الذي ينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وغير ذلك من الصفات الكماليّة اللاّئقة بشأنه تبارك وتعالى ، وكذا نزّهه عن أن يكون له ولد ، وعن أخذ السنة والنوم له ، وغير ذلك ممّا يلازم النقص والإمكان.
وكذلك وصف الأنبياء بما ينبغي أن يوصفوا به ، وما يناسب ويلائم مع مقام النبوّة ، وقدس السفارة في آيات كثيرة ، وإن وقع من بعض المعاندين جمع ما يشعر بصدور ما لا يلائم مع مقام النبوّة ، وقدس السفارة من الآيات الظاهرة بدواً في ذلك ، ولكنّه قد اُجيب عنه بأجوبة شافية ، ونزّه الأنبياء من طريق نفس الكتاب ، وبيّن أنّ التأويل في تلك الآيات ، وضمّ البعض يرشد إلى خلافه.
وبالجملة: لا مجال للارتياب في أنّ الكتاب قد وصف الأنبياء بكلّ جميل ، ونزّههم عن كلّ ما لا يليق ، مع قداسة النبوّة.
وامّا كتب العهدين: فتراها في مقام توصيف الله تبارك وتعالى ، وتوصيف الأنبياء السفراء مشتملة على ما لا يرضى به العقل أصلاً ، وما لا ينطبق على
(الصفحة77)
البرهان قطعاً ، وقد تعرّض لكثير من هذه الموارد الشيخ العلاّمة البلاغي (قدس سره) في كتابي الهدى إلى دين المصطفى والرحلة المدرسيّة.
ومن جملة ذلك ما وقع في محكيّ الاصحاح الثاني والثالث من سفر التكوين من كتاب التوراة ، في قصّة آدم وحواء ، وخروجهما من الجنّة ، حيث ذكرت:
«إنّ الله أجاز لآدم أن يأكل من جميع الأثمار إلاّ ثمرة شجرة معرفة الخير والشرّ ، وقال له لأنّك يوم تأكل منها موتاً تموت ، ثمّ خلق الله من آدم زوجته حوّاء ، وكانا عاريين في الجنّة لأنّهما لا يدركان الحسن والقبيح ، وجاءت الحيّة ودلّتهما على الشجرة وحرّضتهما على الأكل من ثمرها وقالت: إنّكما لا تموتان ، بل انّ الله عالم انّكما يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما ، وتعرفان الحسن والقبيح ، فلمّا أكلا منها انفتحت أعينهما وعرفا انّهما عاريان ، فصنعا لأنفسهما مئزراً فرآهما الربّ وهو يتمشّى في الجنّة ، فاختبأ آدم وحوّاء منه ، فنادى الله آدم أين أنت؟ فقال آدم: سمعت صوتك فاختبأت ، لأنّي عريان ، فقال الله: من أعلمك بأنّك عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ ثمّ إنّ الله بعدما ظهر له أكل آدم من الشجرة فقال: هو ذا آدم صار كواحد منّا ، عارف بالحسن والقبيح ، والآن يمدّ يده فيأكل من شجرة الحياة ، ويعيش إلى الأبد فأخرجه الله من الجنّة ، وجعل على شرقيها ما يحرس طريق الشجرة».
وذكر في العدد التاسع من الاصحاح الثاني عشر: انّ الحيّة القديمة هو المدعوّ بإبليس ، والشيطان الذي يضلّ العالم كلّه. وفي محكي الاصحاح الثاني عشر من التكوين:
«إنّ إبراهيم ادّعى أمام فرعون: أنّ سارة اُخته ، وكتم أنّها زوجته ، فأخذها
(الصفحة78)
فرعون لجمالها ، وصنع إلى إبراهيم خيراً بسببهاو وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء واتن وجمال ، وحين علم فرعون أنّ سارة كانت زوجة إبراهيم وليست اُخته قال له: لماذا لم تخبرني انّها امرأتك؟! لماذا قلت: هي اُختي حتّى أخذتها لي زوجة؟! ثمّ ردّ فرعون سارة إلى إبراهيم».
انظر إلى القصّة الاُولى المشتملة على نسبة الكذب إلى الله جل وعلا ، ومخادعته لآدم في أمر الشجرة التي كانت ثمرة الأكل منها حصول المعرفة بالحسن والقبح وإدراكهما ، وفي مقابله نصح الحيّة والشيطان لآدم ، وهدايته إلى طريق المعرفة والإدراك والخروج من الظلمة إلى النور ، مضافاً إلى نسبة الخوف إليه تعالى من أكل آدم شجرة الحياة ، ومعارضته إيّاه في سلطانه ومملكته ، وإلى نسبة الجهل بمكانهما إليه تعالى حين اختبأ ، وإلى إثبات الجسمية له تعالى بحيث يمكن له أن يتمشّى في الجنّة ، ويرى على نحوها ما يرى الجسم ، وبعد ذلك فهو صريح في عدم ثبوت الوحدانية له تعالى ، فإنّ قوله: «صار كواحد منّا» صريح في عدم انحصار الإلوهية في فرد ، وعدم اختصاص مفهوم الواجب بوجود واحد ، مع أنّ نفس هذه القصّة ـ مع قطع النظر عن هذه الإشكالات ـ لا يقبل العقل والذوق مطابقتها للواقع ، فهي بالوضع أشبه.
وانظر إلى القصّة الثانية الدالّة على أنّ إبراهيم ـ وهو من أكرم الأنبياء وأعظمهم ـ صار سبباً لأخذ فرعون زوجته ، ولعلّ الوجه فيه هو الخوف مع أنّه لا يتصوّر فيه خوف ، لأنّ اتّصافها بزوجة إبراهيم لا يكاد يترتّب عليه أثر سوء حتّى يخاف منه ويسوغ لأجله الكذب في دعوى الاُختيّة ، مع أنّه على تقديره كيف يرضى الفرد العادي في هذه الحال ـ وهي شدّة الخوف بذلك ـ فضلاً عن مثل
(الصفحة79)
إبراهيم ، الذي هو الأساس ، والركن العظم في باب التوحيد والشريعة ، وقصّته في المعارضة مع عبدة الأصنام مشهورة.
فانقدح من ذلك: أنّ ملاحظة القرآن من جهة المعارف الاعتقادية ، والاُصول الراجعة إلى المبدأ وأوصافه ، والأنبياء وخصائصهم ، ممّا يرشد إلى اتّصافه بالإعجاز ، مع قطع النظر عن الجهات الكثيرة الاُخر ، الهادية إلى هذا الغرض المهمّ ، والمقصد العظيم.
(الصفحة80)
القرآن وقوانينه التشريعيّة
من جملة وجوه الإعجاز الكثيرة: رعاية القرآن في نظامه وتشريعه ، سيّما في المقايسة مع المقرّرات الرائجة في عصر نزول القرآن ، وورود قوانينه وشرائعه ، وتلك المقرّرات أعمّ من القوانين الشائعة بين الطائفة الوثنية ، التي تكون العمدة فيها عبادة الآلهة المصنوعة ، واتّخاذها شفعاء إلى الله تعالى ، وبعد ذلك شيوع النهب والغارة بينهم ، وابتهاجهم بإقامة الحروب والمعارك ، وقتل الأنفس واغتنام الأموال ، وشيوع الاستقسام بالأنصاب والأزلام ، واعتيادهم لشرب الخمر ، واللعب بالميسر ، وافتخارهم بذلك ، والتزويج بنساء الآباء ، ودسّ البنات في التراب ، كما حكاه القرآن بقوله تعالى: {وإذا بشّر أحدهم بالاُنثى ظلّ وجهه مسودّاً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشّر به أيمسكه على هون أم يدسّه في التراب}(1).
ولكنّ البناء العملي غالباً إنّما كان على الدسّ والدفن في حال الحياة.
ومن القوانين الشائعة بين أهل الكتاب التابعين لكتب العهدين المحرّفة; فإنّ التوراة ـ مع كبر حجمها ـ لا يكون فيها مورد تعرّضت فيه لوجود القيامة ، وعالم الجزاء على الأعمال أصلاً ، مع أنّه من الواضح أنّ الغرض الأقصى والمطلوب الأوّلي
(1) النحل: 59.
|