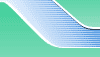(الصفحة101)
«اليوم».
وممّا استعمل فيه لفظ الليل واُريد به المجموع قوله تعالى في سورة البقرة 51: {وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة} وكذا الآية المبحوث عنها في المقام المشتملة على كلمة «الليل».
فانقدح أنّه لا منافاة بين الآيتين ، ولا مناقضة بين الكريمتين ، فلا موقع للشبهة في البين.
ثانيهما: أنّ الكتاب كثيراً ما يسند الفعل إلى العبد واختياره ، فيدلّ ذلك على عدم كونه مجبوراً في أفعاله ، وقد يسنده إلى الله تبارك وتعالى وهذا ظاهر في أنّ العبد مجبور في أفعاله ، وأنّه ليس له اختيار إلاّ اختياره تعالى.
فمن الأوّل: قوله تعالى في سورة الكهف 29: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} وقوله تعالى في سورة الإنسان 3: {انّا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً}.
ومن الثاني: قوله تعالى في سورة الإنسان ـ 3: {وما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله}قالوا: وهذا تناقض صريح وتهافت محض.
والجواب:
أمّا كون الإنسان مختاراً في أفعاله الاختياريّة ، غير مجبور بالإضافة إليها ، قادراً على الفعل والترك فمّما يدركه الإنسان بالفطرة السليمة ، ولا يشكّ فيه عند استقامتها ، وعدم الانحراف عنها ، وهذا الأمر ـ أي كون العبد مختاراً غير مجبور ـ ممّا أطبق عليه العقلاء كافّة ، وبنوا عليه اُموراً كثيرة ، فإنّ القوانين الوضعية عندهم لغرض التنفيذ والموافقة لا يكاد يمكن فرض صحّتها وواجديتها للشرائط المعتبرة
(الصفحة102)
في التقنين إلاّ مع مفروغيّة اختيار الإنسان في أفعاله وأعماله ، ضرورة أنّه لا معنى لسنّ القانون بالإضافة إلى غير المختار ، فإنّ القانون إنّما يكون الغرض منه الانبعاث والموافقة ، وهو لا يعقل تحقّقه بدون الإرادة والإختيار.
وكذا الأوامر والنواهي الصادرة من الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم ، إنّما تتفرّع على كون اتّصاف العبيد بالقدرة والاختيار أمراً ضروريّاً عند العقلاء ، ولا ارتياب فيه عندهم أصلاً.
وكذا التحسين والتقبيح العقلائيّان اللّذان هما من الموضوعات المسلّمة عند العقلاء ، والأحكام الضروريّة لديهم ، إنّما يتفرّعان على هذا الأمر الذي ذكرناه ، بداهة أنّه لا وجه لاتّصاف العمل غير الاختياري بالحسن أو القبح ، ومن عدم الاتصاف لا يبقى موقع للمدح أو الذمّ.
وبالجملة: لا ينبغي الارتياب في أنّ اتّصاف الإنسان بالاختيار في أفعاله الإرادية وصحّة اسنادها إليه ـ لأنّه فاعل مختار ـ من الاُمور البديهيّة عند العقلاء ، الذين هم الحكّام في باب التقنين ، وجعل الأحكام ، وما يتفرّع عليه من الإطاعة والعصيان واستحقاق المدح أو الذمّ ، والجنان أو النيران ، وما هو بمنزلتهما من المثوبات والعقوبات الدنيويّة.
ومع قطع النظر عن جميع ما ذكرنا أنّ العاقل يرى الفرق الواضح بين حركة يد المرتعش ، والحركة الاختيارية الصادرة من غيره ، ولا يرتاب في المغايرة البيّنة بين سقوط الإنسان من شاهق إلى الأرض قهراً ، وبين إسقاطه نفسه منه إليه اختياراً ، فيرى أنّه مختار في الثانية دون الاُولى ، ويستحقّ الذمّ فيها دونها.
فانقدح أنّ اتّصاف الإنسان بالاختيار ـ الذي هو المصحّح لاسناد الأفعال
(الصفحة103)
الاختيارية الصادرة منه إليه ـ ممّا لا ريب فيه عند العقل والعقلاء ، ولا شكّ فيه عند الوجدان أصلاً.
وأمّا صحّة إسناد هذه الأفعال ـ التي تسند إلى الإنسان حقيقة ـ إلى الله تبارك وتعالى بالاسناد الخالي عن العناية والمسامحة ، فلأنّ واجب الوجود لم ينعزل عن خلقه بعد الإيجاد ، لما ثبت في محلّه ـ من العلم الأعلى ـ من أنّ الممكن كما يفتقر في حدوث وجوده ، وتلبّسه بلباس الوجود إلى العلّة ، كذلك يحتاج في البقاء والاستمرار إليها ، لأنّ الافتقار والحاجة من لوازم ذات الممكن وماهيّته ، قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر 15:
{يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيّ الحميد}.
وقال الشاعر الفارسي:
سيه روئى ز ممكن در دو عالم *** جدا هر گز نشد و الله أعلم
فمثل الموجودات الممكنة إلى خالقها وبارئها ليس كمثل البناء والكتاب إلى البنّاء والكاتب ـ حيث لا حاجة في بقائهما إلى بقاء صانعهما ـ أو مثل الولد إلى والده ـ حيث يستغني الولد في بقائه عن بقاء والده ـ بل مثلها إليه تبارك وتعالى مثل شعاع الشمس ونورها إليها ، فإنّه يحتاج إليها حدوثاً وبقاءً ، كما أنّ نور الوجود لا يعقل بقاؤه بدون علّته الواجبة ، وكذا مثل الضوء بالإضافة إلى القوّة الكهربائية المؤثِّرة في إيجاده ، فإنّه لا يزال يفتقر في بقائه إلى الاستمداد من تلك القوّة ، كما أنّه كان في حدوثه محتاجاً إلى اتّصال سلكه بمصدر تلك القوّة.
وبالجملة: من البديهيّات الواضحة الثابتة في العلم الأعلى ، أنّ الممكن ـ كما أنّه يحتاج حدوثاً إلى إفاضة الوجود عليه من المبدع الأوّل ـ كذلك يفتقر في بقائه
(الصفحة104)
إلى الاستمداد منه واتّصاله بالمبدأ الأعلى ، بل قد ثبت في ذلك العلم أنّ الممكن ليس شيئاً له الارتباط الذي مرجعه إلى وصف زائد على حقيقته ، بل ذاته عين الربط وحقيقته محض الاتّصال ، فكيف يعقل ـ حينئذ ـ غناؤه وخلوّه عن الربط الذي هو ذاته وحقيقته؟!.
إذا عرفت ذلك; يظهر لك صحّة إسناد الأفعال الاختيارية الصادرة من الممكنات إلى خالقها أيضاً ، ضرورة أنّه من جملة مبادئ الفعل الاختياري ، الذي هو الركن العظيم في صدوره وتحقّقه ، هو نفس وجود الفاعل بداهة أنّه مع عدمه لا يعقل صدور فعل اختياري منه ، فوجوده أوّل المبادئ ، وأساس المقدّمات.
ومن المعلوم أنّ هذه المقدّمة خارج عن دائرة قدرة الفاعل واختيار الإنسان ضرورة أنّه يكون باختيار العلّة المؤثِّرة التي يحتاج إليها الإنسان ـ حدوثاً وبقاءًـ فالفعل الاختياري الصادر من الإنسان بما أنّ بعض مباديه خارج عن تحت قدرته واختياره ، بل يكون باختيار العلّة الموجدة يصحّ إسناده إليها.
وبما أنّ بعض مباديه كالإرادة الحاصلة بخلاّقيّة النفس وإفاضتها ـ التي هي أيضاً عناية من العلّة صاحبة المشيئة والإرادة ، وإفاضة حاصلة من ناحيتها ، وعطيّة واصلة من جانبها ومظهر للخلاّقيّة الموجودة فيها ـ باختياره وإرادته يصحّ اسناده إلى نفسه ، ضرورة أنّ صحّة الاسناد لا تلازم الاستقلال فإنّ مرجع وصف الاستقلال ـ بمعناه الحقيقي ـ إلى أن يكون سدّ جميع الاعدام الممكنة ، حتّى العدم الجائي من قبل عدم الفاعل باختياره وإرادته ، مع انّا فرضنا عدم ثبوت الاستقلال بهذا المعنى ، لأنّ وجود الفاعل ـ الذي قد عرفت أنّه الركن العظيم في صدور الفعل الاختياري ـ خارج عن حريم اختياره ، لكن هذا الأمر ينافي الاستقلال ، لا صحّة
(الصفحة105)
الاسناد إلى الفاعل المختار.
والظاهر: وقوع الخلط بين هذين العنوانين بحيث توهّم أنّ صحّة الاسناد إلى الفاعل ملازمة لاختصاص الاسناد به ، الذي مرجعه إلى استقلاله في صدور الفعل ، مع أنّ الغرض مجرّد صحّة الاسناد بنحو الحقيقة.
وبعبارة اُخرى: المقصود إثبات الاسناد إليه فقط ، لا نفي اسناده إلى غيره أيضاً.
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الفعل الاختياري الصادر عن الإنسان ، كما أنّه منسوب إلى فاعله ومريده ، كذلك منسوب إلى الواجب الذي هي العلّة الموجدة للفاعل ، وهو يحتاج إليها حدوثاً وبقاءً ، وهذا هو الأمر بين الأمرين ، والطريقة الوسطى المأخوذة من إرشادات أهل البيت ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ والأمران هما التفويض الذي مرجعه إلى استقلال الممكن في أفعاله ، والقائل به أخرج من الممكن عن حدّه إلى حدّ الواجب بالذات فهو مشرك ، والجبر الذي مرجعه إلى سلب التأثير عن الممكن ومزاولته تعالى للأفعال والآثار مباشرة من دون واسطة والقائل به حطّ الواجب عن علوّ مقامه إلى حدود الممكن ، فهو كافر ، ولقد سمّى مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ على رواية الصدوق في العيون ـ القائل بالجبر كافراً ، والقائل بالتفويض مشركاً.
واذن فلا محيص عن القول بالأمر بين الأمرين الذي هو الطريقة الوسطى لمن كان على دين الإسلام الحنيف ، وإليه يرشد قول الله تبارك وتعالى في بعض المواضع من كتابه العزيز كقوله في سورة الأنفال 17: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}فأثبت الرمي من حيث نفاه ، ومرجعه إلى صدور الرمي اختياراً من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
(الصفحة106)
وعدم استقلاله في ذلك.
وكقوله تعالى في الآية التي هي محلّ البحث:
{وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله} فإنّ مفادها ثبوت المشيّة لله من حيث كونها لهم ، فمشيّة الممكن ظهور مشيّة الله ، وعين الارتباط والتعلّق بها ، وبذلك ظهر الجواب عن إشكال المناقضة المتقدّم ، ولكن لتوضيح ما ذكرنا ينبغي إيراد أمثلة فنقول:
منها: انّ الأفعال الصادرة من الإنسان بسبب اليد والرجل والسمع والبصر وغيرها من الأعضاء تصحّ نسبتها إلى نفس تلك الأعضاء ، فيقال: رأت العين وسمعت الاُذن ، وضربت اليد ، وتحرّكت الرجل مثلاً ، وأيضاً تصحّ نسبتها إلى النفس الإنسانيّة التي هي المنشأ لصدور كلّ فعل وهي التي يعبَّر عنها بـ «أنا» فيقال: رأيت وسمعت ، وضربت ، وتحرّكت ونحوها ، ومثل الموجودات الممكنة إلى باريها وخالقها ـ والمثال يقرب من وجه ـ مثل تلك الأعضاء إلى النفس.
ومنها: النور الحاصل في الجدار ، المنعكس من المرآة الواقعة في محاذاة الشمس وإشراقها ، فإنّ هذا النور كما أنّه يرتبط بالشمس ـ لأنّ المرآة ليس لها بذاتها نور ، لعدم نور لها كذلك ليس من الشمس المطلق أي من دون وسط وقيد ، بل هو نور شمس المرآة فيصحّ انتسابه إلى كلّ واحد منهما ، لدخالته في تحقّقه ، وارتباطه بكلّ واحد.
ومنها: ما فرضه بعض الأعلام من أنّه لو كان إنسان يده شلاّء لا يستطيع تحريكها بنفسه ، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادة وقتيّة بواسطة قوّة الكهرباء ، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك المشتمل على تلك القوّة ،
(الصفحة107)
وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها فلا شبهة في أنّ هذا التحريك من الأمر بين الأمرين ، لأنّه لا يكون مستنداً إلى الرجل مستقلاًّ ، لعدم القدرة عليه بدون إيصال القوّة إلى يده ، ولا يكون مستنداً إلى الطبيب مستقلاًّ ، لأنّ صدوره كان من الرجل بإرادته واختياره ، فالفاعل لم يجبر على فعله لأنّه مريد له ، ولم يفوّض إليه الفعل بجميع مباديه ، لأنّ المدد من غيره ، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا القبيل.
وقد انقدح ـ بحمد الله ـ ممّا ذكرنا مع إجماله واختصاره بطلان مسلكي الجبر والتفويض ، وانّ غاية ما يقتضيه التحقيق الفلسفي هو ما أرشدنا إليه الأئمّة المعصومون ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ من ثبوت الأمر بين الأمرين ، وصحّة اسناد الأفعال الاختيارية إلى الإنسان وإلى موجده ، والملاك في صحّة توجّه التكليف ، وترتّب المثوبة والعقوبة على الإطاعة والمعصية هو هذا المقدار ، وهو صحّة الاسناد حقيقة من دون أن يكون الاستقلال أيضاً معتبراً فيه ، ضرورة أنّ المناط هو صدور الفعل اختياراً ، ووجوده مسبوقاً بالإرادة بمباديها ، وهو موجود.
ويرشد إلى ما ذكرنا الجملة المعروفة: «لا حول ولا قوّة إلاّ بالله» فإنّها تفيد أنّ الحول ولاقوّة على إيجاد الأفعال إنّما ينتهي إلى الله ، ويستمدّ منه ، ولا يمكن أن يتحقّق مع قطع النظر عن الله والارتباط إليه ، فالحول والقوّة المصحّح لإيجاد الفعل ، والاقتداء عليه موجود ، ولكن الأساس هو الاتّصال به تعالى ، وهذا كما إذا كان إنساناً عاجزاً عن إيجاد فعل وأقدره الآخر عليه ، فأوجده بإرادته واختياره ، كما إذا كان الفعل متوقّفاً على صرف مال ، وهو لا يكون متمكِّناً منه بوجه ، فبذل الآخر إيّاه ذلك المال ، فقدر على إيجاده فأوجده ، فإنّه مع كون الفعل صادراً بإرادة
(الصفحة108)
الفاعل واختياره لا مجال لإنكار كون القدرة على إيجاده ناشئة من صاحب المال الباذل له إيّاه ، ومع ذلك لا يكون التحسين والتقبيح متوجّهاً إليه أصلاً ، لأنّ الملاك فيها هو صدور العمل الحسن أو القبيح بالمباشرة ، ولا يتعدّى عن الفاعل بالإرادة إلى غيره ممّن كان دخيلاً في صدور الفعل ، وتحقّق القدرة عليه إلاّ إذا انطبق عليه عنوان مباشري ، كالإعانة على الإثم ، أو على البرّ والتقوى ، فيصير ذلك العنوان لأجل كونه مباشريّاً ، موجباً لتوجّه التحسين أو التقبيح إليه ، فتأمّل جيّداً.
3 ـ ومنها: أي من الشبهات المتعلّقة بإعجاز القرآن: انّ عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن لا دلالة فيه على كونه معجزاً مرتبطاً بمبدأ الوحي ، خارقاً للعادة البشريّة والنواميس الطبيعيّة ، فإنّ مثل كتاب «اقليدس» وكتاب الشاعر والأديب الفارسي المعروف: «سعدي» يكون البشر عاجزاً عن الإتيان بمثله ، فلا محيص ـ حينئذ ـ عن اتّصافه بكونه معجزاً ، لعدم الفرق بينه وبين القرآن ، فلا وجه لاتصافه بكونه كذلك ، كما هو ظاهر.
والجواب:
انّا قد ذكرنا في بحث حقيقة المعجزة: انّ للمعجز الاصطلاحي شروطاً متعدّدة ، وكثير منها مفقود في مثل الكتابين المذكورين ، فانّا قد حقّقنا فيما تقدّم انّه يعتبر في المعجز أن يكون مقروناً بدعوى منصب إلهي ، وأن يكون الإتيان به في مقام التحدّي الراجع إلى دعوة الناس إلى الإتيان بالمثل ، نظراً إلى أنّ توصيف البشر بالعجز الذي هو من النقائص التي يتنفّر عن الاتّصاف بها ، وينزجر عن الاقتران به يوجب صرف جميع ما باختيارهم من القوى والإمكانات في الإتيان بالمثل ، لرفع هذه النقيصة وإبطال هذه التّهمة ، مضافاً إلى أنّ البشر يأبى بالطبع عن
(الصفحة109)
أن يلقى طوق إطاعة الغير ، الذي هو من جنسه على عنقه وأن يعتقد بتفوّقه عليه ، ولزوم إطاعته له ، فيسعى في إبطال دعوى المدّعى لذلك إذا كان الإبطال في مقدرته وإمكانه.
وكذا ذكرنا فيما تقدّم: انّه يعتبر في المعجز أن يكون خارجاً عن نواميس الطبيعة ، وخارقاً للعادة البشريّة ، ومن المعلوم عدم ثبوت هذه الاُمور في الكتابين وأمثالهما ، امّا عدم ثبوت الأمرين الأوّلين فواضح ، ضرورة عدم ثبوت دعوى منصب إلهي ، وعدم وقوع التحدّي بالإضافة إلى الكتابين ، وامّا عدم ثبوت الأمر الأخير فلأنّ الإتيان بمثل الكتابين لا يكون بممتنع عادةً أصلاً ، خصوصاً لو اُريد الامتناع ولو اجتمع أزيد من واحد ، كما هو ظاهر.
4 ـ ومنها: أنّ ما نراه ونقطع به هو أنّ العرب لم تعارض القرآن ، ولم تأت بما هو مثله ولو سورة منه ، إلاّ انّه لم يعلم أنّ عدم الإتيان كان مسبّباً عن عدم القدرة ، وعدم الاستطاعة على الإتيان بمثله حتّى يتّصف القرآن معه بالإعجاز ، فلعلّ عدم الإتيان كان معلولاً لجهات اُخرى لا تعود إلى الإعجاز ، ولا ترتبط به ، بل الاعتبار والتاريخ يساعدان ذلك نظراً إلى أنّ العرب الذين كانوا معاصرين للدعوة ، أو متأخّرين منها بقليل ، فلقد كانت تمنعهم عن التصدّي لذلك ، والورود في هذا المجال الخوف الناشئ من سيطرة المسلمين واقتدارهم ، المانع عن تجرّي العرب على القيام بمعارضة القرآن الذي هو الأساس في الإسلام ، وصدق النبوّة ، وبعد انقراض الخلفاء الأربعة وتصدّي الأمويّين للزعامة الإسلامية صار القرآن مأنوساً لجميع الأذهان ، راسخاً في القلوب ، ولم يبق معه للقيام بالمعارضة مجال.
والجواب:
(الصفحة110)
انّ عدم الإتيان بمثل القرآن في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وحياته لا يتصوّر له وجه ، ولا يعقل له سبب غير العجز وفقدان القدرة من دون فرق بين الزمان الذي كان في مكّة المكرّمة والزمان الذي أقام (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة المشرّفة.
أمّا البرهة الاُولى ـ مع وقوع التحدّي فيها ـ فواضح من أنّه لم يظهر للإسلام في تلك البرهة شوكة ، ولا للمسلمين مع قلّة عددهم اقتدار وسيطرة ، بل كان الخوف ثابتاً لهم عمّا يشهد به التاريخ ويساعده الاعتبار ، فما الذي منع الكفّار من العرب في هذه البرهة من الزمن عن الإتيان بمثل القرآن ، مع أنّهم تشبّثوا بكلّ طريق إلى إطفاء نور النبوّه ، وإرضاء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) برفع اليد عن الدعوة ، والإغماض عن الكلمة ، ولو بتفويضهم إليه الزعامة والحكومة ، وتمكينه من الأموال والثروة ، والأبكار من النساء الجميلات ، ومن المعلوم أنّه لو كان فيهم من يقدر على الإتيان بسورة مثل القرآن لما احتاجوا إلى الخضوع في مقابله بمثل ذلك الخضوع ، الكاشف عن الاضطرار والعجز الذي يتنفّر كلّ إنسان بطبعه عن الاتّصاف به.
ويدلّ على ما ذكرنا ما قاله الوليد بن المغيرة حينما سأله أبو جهل ، وأصرَّ عليه أن يقول في القرآن قولاً ممّا هذا لفظه المحكيّ: «فما أقول فيه فوالله ما منكم رجل أعلم في الأشعار منّي ، ولا أعلم برجزه منّي ، ولا بقصيدته ، ولا بأشعار الجنّ ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، والله انّ لقوله لحلاوة ، وانّه ليحطّم ما تحته ، وانّه ليعلو ولا يُعلى عليه» قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتّى تقول فيه ، قال الوليد: فدعني حتّى أفكّر فيه ، فلمّا فكّر قال: «هذا سحر يؤثره من غيره».
اُنظر إلى هذا الاعتراف الصادر عمّن يدّعي الأعلميّة في الجهات الأدبيّة ، الراجعة إلى الفصاحة والبلاغة ، ويصدّقه فيه المخاطب ، ولأجله تشبّث به ، ورجع
(الصفحة111)
إليه ، وأصرّ عليه أن يقول في القرآن قولاً ، فمع مثل هذا الاعتراف هل يتوهّم عاقل أن تكون العلّشه لعدم الإتيان بمثل القرآن غير العجز ، وعدم القدرة ، خصوصاً مع تصريحه بأنّه يحطّم ما تحته ، وانّه يعلو ولا يُعلى عليه.
وامّا البرهة الثانية التي كان الرسول فيها مقيماً بالمدينة المشرّفة فالدليل على عجزهم عن الإتيان بما يماثل القرآن في تلك البرهة ما أشرنا إليه من اختيارهم المبارزة بالسنان ، والمقابلة بالسيوف على المعارضة بالبيان ، والمقابلة بالحروف ، مع أنّه ليس من شأن العاقل ـ مع القدرة والاستطاعة ـ على إسقاط دعوى المدّعي والتحفّظ على عقيدته ومرامه ، وصون جاهه ومقامه ، من طريق البيان ، وتلفيق الحروف ، وتأليف الكلمات أن يدخل من باب المحاربة ، ويعدّ نفسه للمنازعة المستلزمة للخطر والمهلكة ، وصرف أموال كثيرة ، وتحمّل مشاق غير عديدة. وإذن فالدليل الظاهر على عجزهم في تلك المدّة وقوع الغزوات الكثيرة بينهم وبين المسلمين!.
وأمّا بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وزمن الخلفاء ، وسيطرة المسلمين فقد كان أهل الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزيرة العرب وغيرها ، وكانوا لا يخافون من إظهار مرامهم ، وإنكارهم لدين الإسلام ، وعدم اعتقادهم به ، فكيف يحتمل خوفهم من الإتيان بما يعارض القرآن ويماثله ، لو كانوا قادرين على ذلك.
وأمّا ما ذكره المتوهّم أخيراً من أنّه بعد انقراض عهد الخلفاء الأربعة ، ووصول النوبة إلى الأمويّين صار القرآن مأنوساً لجميع أذهان المسلمين ، بحيث لم يبق مجال لمعارضته بعد رسوخه وتكرّره.
فالجواب عنه: أنّ مقتضى الطباع البشرية أن يكون التكرار للكلام وإن بلغ ما
(الصفحة112)
بلغ من البلاغة وارتفع مقامه من الفصاحة ـ موجباً لنزوله وهبوطه عن ذلك المقام المرتفع ، بحيث ربما يبلغ إلى حدّ التنفّر والاشمئزاز ، هذا لا يختصّ بالكلام ، بل يجري في جميع ما يوجب التذاذ الإنسان من المحسوسات ، فإنّ اللّذة الحاصلة منها في الإدراك الأوّل لا ينبغي أن تقاس مع ما يحصل منها في الثاني والثالث ، وهكذا بل تنقص في كلّ مرّة إلى حدّ تبلغ العدم ، بل تتبدّل إلى الضدّ.
وأمّا القرآن فلو لم يكن معجزاً صادراً من مبدأ الوحي ، ومعدن العلم لكان اللاّزم جريان ما لسائر الكلمات فيه أيضاً ، مع أنّا نرى بالوجدان أنّ القرآن على كثرة تكراره وترديده لا يزداد إلاّ حسناً وبهجة ، ويحصل للإنسان من العرفان واليقين والايمان والتصديق واللذّة الروحانيّة ما لم يكن يحصل له من قبل.
قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصف القرآن وشأنه: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن ، فإنّه شافع مشفع ، وماحل مصدق ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدلّ على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم ، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه ، مصابيح الهدى ومنار الحكمة ، ودليل على المغفرة لمن عرف الصفة ، فليجل جالي بصره ، وليبلغ الصفة نظره ينج من عطب ، ويتخلّص من نشب ، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير ، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص».
ولعمري انّ هذا لا يفتقر إلى توصيف من النبيّ والأئمّة المعصومين ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ بل نفس الملاحظة الخالية عن التعصّب والعناد تهدي
(الصفحة113)
الباحث المنصف إلى ذلك ، من دون حاجة إلى البيان ، وتوضيح وتبيان.
كما أنّ الإنصاف أنّ هذا وجه مستقلّ من وجوه إعجاز القرآن ، فإنّ الكلام الآدمي ولو وصل إلى مراتب الفصاحة والبلاغة يكون تكرّره موجباً لنزوله وسقوطه وهبوطه عن تلك المرتبة ، وأمّا القرآن فكما يشهد به الوجدان لا يؤثِّر فيه التكرار إلاّ التذاذاً ، ولا يوجب ترديده إلاّ بهجة وحسناً ، وليس ذلك إلاّ لأجل كونه كلام الله النازل لهداية البشر إلى يوم القيامة ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، فنفس هذه الجهة ينبغي أن تعدّ من وجوه الإعجاز ، كما لا يخفى.
5 ـ ومنها: انّ اسلوب القرآن يغاير اسلوب الكتب البليغة المعروفة ، لأنّه قد وقع فيه الخلط بين المواضيع المتعدّدة ، والمطالب المتنوّعة فبينا هو يتكلّم في اُصول العقائد والمعارف الحقّة إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد ، أو إلى الحكم والأمثال ، أو إلى بيان بعض الأحكام الفرعيّة ، وهكذا ، كما أنّه في أثناء نقل التاريخ مثلاً ينتقل إلى المعارف ، ولو كان القرآن مشتملاً على أبواب وفصول وكان كلّ باب متعرّضاً لجهة خاصّة وناحية معيّنة لكانت الفائدة أعظم والاستفادة أسهل ، ضرورة إنّ المراجع إليه لغرض المعارف فقط يلاحظ الباب المخصوص به ، والفصل المعقود له ، والناظر فيه لغرض الأحكام لم يكن متحيّراً ، بل كان يراجع إلى خصوص ما عقد له من الفصل أو الباب ، وهكذا.
ففي الحقيقة انّ القرآن مع اسلوبه الموجود المغاير لأسلوب الكتب المنظّمة المشتملة على فصول متعدّدة حسب تعدّد مطالبها ، وأبواب متنوّعة حسب تنوّع أغراضها وإن لم يكن البشر العادي قادراً على الإتيان بمثله والقيام بمعارضته إلاّ أنّه مع ذلك لا يكون حائزاً للمرتبة العليا من البلاغة ، والدرجة القصوى من المتانة
(الصفحة114)
والتنسيق لعدم كونه مبوّباً كما عرفت.
والجواب:
انّه لابدّ من ملاحظة أنّ الغرض الأصلي من القرآن ونزوله ماذا؟ فنقول: ممّا لا يرتاب فيه كلّ باحث وناظر أنّ القرآن اُنزل لهداية البشر ، وسوقهم إلى السعادة في الدارين ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم 1:
{كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور}.
وليس هو كتاب فقه ، أو تاريخ ، أو أخلاق ، أو كلام ، أو فلسفة ، أو نحوها ومن المعلوم انّ الاسلوب الموجود أقرب إلى حصول ذلك الغرض من التبويب ، وجعل كلّ من تلك المطالب في باب مستقلّ ، فإنّ الناظر في القرآن ـ مع الوصف الفعلي ـ يطلع عى كثير من أغراضه ، ويحيط بجلّ من مطالبه الدخيلة في حصول الغرض المقصود في زمان قصير ، فبينما يتوجّه إلى المبدأ والمعاد ـ مثلاً ـ يطّلع على أحوال الماضين المذكورة للتأييد والاستشهاد ، ويستفيد من أخلاقه ، وتقع عينه على جانب من أحكامه ، كلّ ذلك في وقت قليل ، ففي الحقيقة يقرب قدماً بل أقداماً إلى ذلك الهدف ، ويرتقي درجة إلى تلك الغاية فهو ـ أي القرآن ـ كالخطيب الذي يكون الغرض من خطابته دعوة المستمعين وهدايتهم ، وسوقهم إلى السعادة المطلوبة في الدنيا والآخرة ، فإنّه يفتقر في الوصول إلى غرضه إلى الخلط بين المطالب المتنوّعة ، وايراد فنون متعدّدة ، لئلاّ يملّ المستمع أوّلاً ، ويقع في طريق السعادة من جهة تأييد المطلب بقصّة تاريخية ، أو حِكَم أخلاقية ، أو مثلهما ثانياً.
فانقدح انّ الاسلوب الموجود إحدى الجهات المحسنة ، والفضائل المختصّة
(الصفحة115)
بالقرآن الكريم ، ولا يوجد مثله في كتاب ، والسرّ فيه ما عرفت من امتيازه من حيث الغرض ، وخصوصيّته من جهة المقصود ، الذي يكون اسلوبه هذا أقرب إلى الوصول إليه.
6 ـ ومنها: انّه قد مرّ في بيان حقيقة المعجزة ، والاُمور المعتبرة في تحقّقها أنّ من جملتها السلامة من المعارضة ، وهذا الأمر لم يحرز في القرآن ، فإنّه من الممكن أنّه كان مبتلى بالمعارضة ، وانّه قد أتى بما يماثل القرآن ، وقد اختفى علينا ذلك المماثل ، ولعلَّ سيطرة المسلمين واقتدارهم اقتضت خفاءه وفناءه ولولا ذلك لكان إلى الآن ظاهراً.
والجواب عنه:
أمّا أوّلاً: فقد أثبتنا في مقام الجواب عن بعض الشبهات السابقة عجزهم ، وعدم اقتدارهم على الإتيان بمثل القرآن ، ومعلوم انّه مع ثبوت عجزهم لا يبقى موقع لهذا الوهم ، لأنّه يتفرّع على عدم الثبوت ، كما هو واضح.
وامّا ثانياً: فالدليل على عدم الإتيان بالمعارض ، انّ المعارضة لو كانت حاصلة لكانت واضحة ظاهرة ، غير قابلة للاختفاء ، ولو طال الزمان كثيراً ، ضرورة انّ المخالفين لهذا الدين القويم ، والمعاندين لهذه الشريعة المستقيمة ، كانوا من أوّل اليوم كثيرين ـ كثرة عظيمة ـ وكانوا مترصّدين لما يوجب ضعف الدين ، وسلب القوّة عن المسلمين ، فلو كانت المعارضة ولو بسورة واحدة مثل القرآن موجودة لكانت تلك لهم حجّة قويّة ، ليس فوقها حجّة ، وسلاحاً مؤثّراً ليس فوقه سلاح ، وسيفاً قاطعاً لا يتصوّر أقطع منه ، فكيف يمكن أن يرفعوا أيديهم عن مثل ذلك ، بل المناسبة تقتضي شهرتها ، وظهورها بحيث لا يخفى على أحد.
(الصفحة116)
مع أنّه لم يكن ـ حينئذ ـ وجه لبقاء المسلمين على إسلامهم ، فإنّهم لم يكونوا ليتديّنوا بالدين الحنيف تعبّداً ، ولم يخضعوا دون النبي الصادع للشرع تعصّباً ، بل كان ذلك لاجتماع شروط المعجزة في القرآن الكريم ، وعدم اقتدار أحد على المعارضة مع الكتاب المجيد ، كما هو ظاهر.
فانقدح: انّ المعارض لو كان لبان ، ولم يبق تحت سترة الخفاء والكمون ، فاحتمال وجود المانع عن تحقّق الإعجاز ممّا لا يتحقّق من الباحث غير المتعصّب ، والطالب غير العنود أصلاً.
7 ـ ومنها: انّ التاريخ قد ضبط جماعة تصدّوا الإتيان بما يماثل القرآن ، وأتوا بسورة أو أزيد ، بل بكتاب يزعمون أنّه لا فرق بينه وبين الفرقان ، ولعلّ ملاحظة ظاهره تقضي بصحّة ما يقولون ، واذن فلا يبقى موقع لاتّصاف القرآن بالإعجاز ، لوجود المعارض ، بل المعارضات المتعدّدة. وقد مرّ أنّ من شروط الإعجاز سلامة المعجزة عن المعارضة.
والجواب:
انّه لابدّ من ملاحظة حالات تلك الجماعة ، وخصوصيات حياتهم ، والنظر فيما أتوا به ـ بعنوان المماثلة ـ ليظهر الحال ، وانّ ما أتي به هل كان لائقاً بأن يتّصف بهذا العنوان ، وصالحاً لأن ينطبق عليه المعارضة للقرآن ، أو أنّ ذلك مجرّد تخيّل وحسبان.
فنقول ـ وعلى الله التكلان ـ : إنّ هذه الجماعة القليلة ، والطائفة اليسيرة بين من كانت له داعية النبوّة والسفارة ، وكان كتابه الذي جاء به بعنوان المعجزة وبين من لم يكن له تلك الداعية ، بل كان يزعم انّه يقدر على الإتيان بالمعارض من جهة
(الصفحة117)
اطّلاعه على الجهات الراجعة إلى البلاغة ، والمميّزات الأدبيّة ، وبين من لم يكن له هذه العقيدة أيضاً ، بل كان له كتاب قد استفاد منه المعاندون ، زعماً منهم انّه في رتبة القرآن ، من حيث البلاغة والفصاحة ، أو اغراءً وإضلالاً من دون زعم واعتقاد.
ولابدّ من النظر في حالاتهم ، وإن كان نفس مخالفة مثل هؤلاء ، وقيامهم في مقام المعارضة ممّا يؤيّد إعجاز القرآن ، ويثبت تفوّقه ووقوعه في المرتبة التي لا تكاد تصل إليها أيدي البشر ، بداهة أنّ الكتاب الذي اعترف بالعجز في مقابله البلغاء المشهورون ، والفصحاء المعروفون ، والاُدباء الممتازون ، وخضع دونه المحقّقون والمتبحِّرون ، تكون مخالفة أمثال تلك الجماعة دليلاً على قصور باعهم ، أو انحرافهم وضلالهم ، وهذا شأن كلّ حقيقة ، وآية كلّ واقعية فإنّ عدم خضوع أفراد قليلة غير ممتازة في مقابلها ، وعدم تسليمهم لها يؤيّد صدقها ، ويدلّ على النقص فيهم ، ولكن مع ذلك لا بأس بالنظر في حالات تلك الجماعة ، وفيما أتوا به بعنوان المعارضة. فنقول:
1 ـ مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذّاب :
كان من أهل اليمامة ، وقد ادّعى النبوّة في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في اليمامة في طائفة بني حنيفة ، وكان ذلك بعد تشرّفه بمحضر النبيّ وقبوله للإسلام ، وكان يصانع كلّ أحد ويتألفه ، ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح ، لأنّه لم يكن له غرض إلاّ الزعامة والرئاسة ، وكان يرى انّ ادّعاء النبوّة طريق إلى الوصول إليها ، وإلاّ فليس لها حقيقة وواقعية ، بل هي نوع من الكهانة الرائجة في تلك الأعصار ، ولذا استدعى من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشركه في النبوّة ، أو يجعله خليفة له بعده ، وقد كتب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) في العاشر من الهجرة: «أمّا بعد فانّي قد شوركت في الأرض معك ، وانّ لنا
(الصفحة118)
نصف الأرض ، ولقريش نصفها ، ولكن قريشاً قوم يعتدون» فقدم عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)رسولان بهذا الكتاب فقال لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال. فقال: أما والله لولا انّ الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما ، ثمّ كتب إلى مسيلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذّاب ، سلام على من اتّبع الهدى امّا بعد فإنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين».
وكانت معه نهار الرجال بن عنفوة ، وكان قد هاجر إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقرأ القرآن وفقّه في الدين ، فبعثه معلِّماً لأهل اليمامة ، وليشغب على مسيلمة ، وليشدّد من أمر المسلمين ، فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة ، شهد له انّه سمع محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم)يقول: إنّه قد أشرك معه ، فصدّقوه ، واستجابوا له ، وأمره بمكاتبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ووعده إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه ، فكان نهار الرجال لا يقول شيئاً إلاّ تابعه عليه ، وكان ينتهي إلى أمره ، وكان يؤذن للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ويشهد في الأذان انّ محمّداً رسول الله ، وكان الذي يؤذِّن له عبدالله بن النواحة ، وكان الذي يقيم له حجر بن عمير ويشهد له ، وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة قال صرح حجير فيزيد في صوته ، ويبالغ لتصديق نفسه وتصديق نهار ، وتضليل من كان قد أسلم فعظم وقاره في أنفسهم.
وكان له باعتقاده معجزات وخوارق عادات شبيهة بمعجزات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)وكراماته ، ومن جملة ذلك انّه أتته امرأة من بني حنيفة تكنّى باُمّ الهيثم ، فقالت: انّ نخلنا لسحق ، وانّ آبارنا لجزر ، فادع الله لمائنا ولنخلنا ، كما دعا محمّد لأهل هزمان ، فقال: يا نهار ما تقول هذه؟ فقال: إنّ أهل هزمان أتوا محمّداً فشكوا بعد
(الصفحة119)
مائهم ، وكانت آبارهم جزراً ، ونخلهم انّها سحق ، فدعا لهم فجاشت آبارهم ، وانحنت كلّ نخلة قد انتهت ، حتّى وضعت جرانها لانتهائها ، فحكت به الأرض حتّى انشبت عروقاً ، ثمّ عادت من دون ذلك فعادت فسيلاً مكمماً ينمى صاعداً قال: دعا بسجل فدعا لهم فيه ، ثمّ تمضمض بفم منه ، ثمّ مجّه فيه فانطلقوا به حتّى فرغوه في تلك الآبار ، ثمّ سقوه نخلهم ففعل المنتهى ما حدثتك ، وبقي الآخر إلى انتهائه ، فدعا مسيلمة بدلو من ماء ، فدعاهم فيه ، ثمّ تمضمض منه ، ثمّ مجّ فيه فنقلوه فأفرغوه في آبارهم ، فغارت مياه تلك الآبار ، وخوى نخلهم وانّما استبان ذلك بعد مهلكه.
ومن جملة ذلك انّه قال له نهار: برّك على مولودي بني حنيفة فقال له: وما التبريك؟ قال: كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمّداً فحنّكه ، ومسح رأسه ، فلم يؤت مسيلمة بصبيّ فحنّكه ومسح رأسه إلاّ قرع ولثغ.
ومنها: انّه دخل يوماً حائطاً من حوائط اليمامة فتوضّأ ، فقال نهار لصاحب الحائط: ما يمنعك من وضوء الرحمن فتسقى به حائطك حتّى يروى ، وينيل كما صنع بنو المهريّة ـ أهل بيت من بني حنيفة ـ وكان رجل من المهريّة قدم على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)فأخذ وضوءه فنقله معه إلى اليمامة ، فأفرغه في بئره ، ثمّ نزع وسقاه ، وكانت أرضه تهوم ، فرويت وجزأت ، فلم تلف إلاّ خضراء مهتزة ، ففعل فعادت يباباً لا ينبت مرعاه.
ومنها: ما في كتاب «آثار البلاد وأخبار العباد» لزكريا بن محمّد بن محمود القزويني من أنّهم طلبوا منه المعجزة ، فأخرج قارورة ضيّقة الرأس ، فيها بيضة فآمن به بعضهم وهم بنو حنيفة أقلّ الناس عقلاً ، فاستخف قومه فأطاعوه ، وبنو
(الصفحة120)
حنيفة اتّخذوا في الجاهلية صنماً من العسل والسمن يعبدونه ، فأصابتهم في بعض السنين مجاعة ، فأكلوه فضحكت على عقولهم الناس وقالوا فيهم:
أكلت حنيفة ربّها *** زمن التقحم والمجاعة
لم يحذروا من ربّهم *** سوء العواقب والساعة
وحكي انّه رأى حمامة مقصوصة الجناح ، فقال: لِمَ تعذِّبون خلق الله ، لو أراد الله من الطير غير الطيران ما خلق لها جناحاً ، وانّي حرّمت عليكم قصّ جناح الطائر ، فقال بعضهم: سل الله الذي أعطاك آية البيض أن ينبت له جناحاً ، فقال: إن سألت فأنبت له جناحا فطار تؤمنون بي؟ قالوا: نعم ، فقال: إنّي اُريد أن اُناجي ربِّي ، فادخلوه معي هذا البيت حتّى أخرجه وافي الجناح ، حتّى يطير فلمّا خلا بالطير أخرج ريشاً كان معه وأدخل في قصبة كلّ ريشة مقطوعة ريشة ممّا كان معه ، فأخرجه وأرسله فطار وآمن به جمع كثير.
وحكي انّه قال في ليلة منكرة الرياح مظلمة: إنّ الملك ينزل إليَّ الليلة ، ولأجنحة الملائكة صلصلة وخشخشة ، فلا يخرجن أحدكم فإنّ من تأمّل الملائكة اختطف ببصره ، ثمّ اتّخذ صورة من الكاغذ لها جناحان وذنب ، وشدّ فيها الجلاجل والخيوط الطوال ، فأرسل تلك الصورة وحملتها الريح والناس بالليل يرون الصورة ، ويستمعون صوت الجلاجل ، ولا يرون الخيط ، فلمّا رأوا ذلك دخلوا منازلهم خوفاً من أن تختطف أبصارهم ، فصاح بهم صائح من دخل منزله فهو آمن ، فأصبحوا مطبقين على تصديقه.
ومنها: غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب التواريخ كالطبري وغيره.
وقد ورد في شأن الرجال بن عنفوة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ما رواه بعض الرواة: من
|